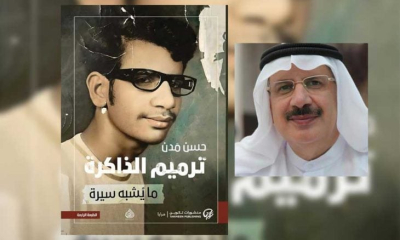يقال إن الذكرى هي الحفاظ على أثر دائم في داخلنا، وإنها أساس المعرفة، فامتلاك ذكريات يعني امتلاك ذاكرة بالفعل. كلما تذكّرنا، تمرنت خزائن ذاكرتنا على التحصيل المعرفي ونقله عبر الأجيال. صحيح هناك ذكريات تستعير الشعور والعاطفة لتبقى صامدة في مقاومة النسيان، وهناك أخرى تستعير الفضول والشغف المعرفي في حد ذاته.
تربطنا الذاكرة بالماضي والحاضر، وحين نوثق لما نتذكره فنحن نصنع مُجمّعًا لذاكرة جماعية، وهذا يخدم الأجيال القادمة إذا ما اعتبرنا كل ذاكرة على حدة جزءا لا يتجزّأ من التجربة الإنسانية غير المكتملة. نعتقد أن ذكرياتنا الحلوة تسكن قلوبنا، ترتبط بمخزون عاطفي جميل، لكن ما يحزننا هو الذكريات الحزينة، التي تقف جنبا إلى جنب معها، لا أفهم هذا القلب كيف صمم، وكيف يجمع في ثناياه بين الألوان المتنافرة وما لا يتعايش مع بعضه.
في تفسير علمي بحت يخرج القلب بريئا من هذه التهمة، إن وظيفته أبعد من جمع الذكريات في تجاويفه، لكنه يتأثر بكل انفعال يأتيه من الإدارة المركزية للجسد «الدماغ». يختلف الأمر حين يخفق القلب نتيجة نوبة غضب، أو انفعال مؤلم، لدى تلقينا خبر فقدان صديق، أو مرض قريب، أو تعرّضنا لصدمة عاطفية، وبين تلقي خبر مفرح. ثمة انتشار غريب لردات الفعل على تنوعها في كامل الجسد، وبعض ردات الفعل تلك تأخذ شكل حالة أبدية تسكننا للأبد. فنعيش الحزن، أو القلق أو الخوف، أو غيره من المشاعر الثقيلة المركبة، التي تجثم على قلوبنا لتصبح مرضا يفسد حياتنا بشكل يومي غير مقبول أبداً. المقبرة التي ندفن فيها ذكرياتنا السيئة تشهد قيامة الموتى في ظروف مفاجئة، هذا إذا لم تتخذ من قبورها تلك، أماكن لمراقبة كل سلوكاتنا المستقبلية.
يقول علم الأعصاب، إن الذكريات السيئة مغروسة بعمق أكثر من الذكريات الجيدة، وهذا ما يجعلها في مأمن أكثر من غيرها، فلا تندثر أبدا، وكلما سنحت لها الفرصة تستيقظ، مصحوبة بخفقان أو رعشة، أو أرق أو كوابيس، أو أي ظاهرة جسدية متعبة لصاحبها. اضطرابات القلق والشعور بالخوف والمعاناة من نقص احترام الذات أمراض في الغالب سببها ذكرى سيئة، قد تعود لطفولة مبكرة، قد تكون توبيخا من أقرب الناس إلينا، بنية تصحيح سلوكنا. فلا أسوأ وقعا على النفس من كلمة سيئة، بقصد أو بغير قصد. وفي ما كثيرون يعتبرون الذكريات السيئة قدرا يجب التعايش معه، فإنّ آخرين وهم قلة يلجأون لعلاج سلوكي معرفي، يساعد على تعديل الأفكار السلبية وتأثيرات الماضي السيئ لتجاوزها والتكيُّف مع حاضرهم بشكل إيجابي.
في السنوات الأخيرة أحرز علم الأعصاب تقدما كبيرا، بحيث اكتشف آليات لمحو الذكريات المؤلمة، وهي آليات موجودة في الدماغ البشري، ولا تحتاج إلا لتفعيل بسيط حين يصر الشخص على التمسك بها وإدمان ألمه. لكن لماذا يفضل البعض الحفاظ على ذاكرة مؤلمة؟ وهل هناك من لديه هذا الخيار أمام الخيار المعاكس له؟
في مذكراته يروي جان بول سارتر: «لقد بدأت حياتي مع الكتب، وبلا شك سأنهيها معها. في مكتب جدي كانت الكتب في كل مكان، وكان ممنوعا نفض الغبار عنها إلا مرة في السنة، قبل الدخول المدرسي في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لم أكن أعرف القراءة بعد، لكني كنت أحترمها، تلك الحجارة المصقولة مثل الطوب على رفوف المكتبة، كنت أعتقد أن رخاء وازدهار العائلة مرتبط بها».
قبل الوقوف عند هذه الفقرة المهمة من كتابه، لنتذكر أن سارتر هو صاحب مقولة: «الجحيم هو الآخرون» وأنه شخص متشائم بشكل مبالغ فيه، لكن ماذا لو سلك طريقا آخر غير طريق الكتب؟ تراه سيكون هذا الشخص الذي حمل هموم الآخرين على عاتقه؟ لقد ظلّ الطفل المنبهر بسلطة الكتب من خلال شخص جده يعشش في ذاكرة سارتر إلى آخر لحظة في عمره، وإن كان البعض يدّعي أن لا دخل للطفولة وذكرياتها في مسارات حياتنا فهو مخطئ، لقد أثبت علم النّفس أن ثنائية الفشل والنّجاح تبنى في تلك المرحلة المبكرة من أعمارنا. مذكرات سارتر التي تعتبر الأشهر على الإطلاق في القرن الماضي، لم تكن مذكرات مبهجة، لقد كان طفلا مسيّجا بالقسوة، وسلطة الآخرين، خاصة جدّه ذا الحضور الكاريزماتي المميز، حتى أن سارتر الصغير لم يكن لديه أي خيار آخر لمقاومة كل ذلك الألم المحيط به، سوى الكتابة حتى حين ذهب للتدريس مثلما خطط له جدّه.
لا داعي للبحث عن أدوية بديلة للفرح المفقود، فلكل مخدّر أمد معين لانتهاء فعاليته، لقد أثبتت الكتابة أنها الريّاضة الأفضل للعقل، وأنها الوحيدة التي تمنحنا فرصة الاختلاء بأنفسنا، وكشف ما انزلق واختفى في البواطن العميقة.
كانت الكتابة انعتاقه الروحي الذي مارسه سرا، قبل أن ينطلق في فضاءاته المفتوحة بجموح غير متوقع. ذلك أن كتابة المذكرات هي كتابة الجانب الآخر من القصة، الجانب الذي لم يصنعه الآخرون، وهذا ما يصنع الفارق. سيكولوجيا الانكباب على كتابة الماضي بكل ذكرياته إعادة لاكتشاف الذات، وفرصة لقياس المسار الذي سلكه الكاتب خلال حياته، وفهم الروابط التي تسببت في أن يكون ما هو عليه.
لكل منّا أسئلة وجودية، مرافعات صامتة تدوي في داخلنا، لكنّنا نرفض البوح بها بسبب مخاوف كثيرة، نلجأ لتغطيتها بسردِ ما يمكن أن يتقبله الآخرون، غير ذلك من الصعب التّحرُّر من سطوة ما تزخر به الذاكرة من محتويات.
ثمة شيء آخر نستسلم له حين تكون أوجاعنا طازجة، عقابا للذات تحت وطأة النّدم، والشعور بالخديعة، والإذلال والظلم. نحتفظ بمشاعر الغضب عسى أن تدفع بنا للانتقام، وكلّما تريّثنا، تسلَّلت الحكمة إلى تصرفاتنا، فإذا بخياراتنا تتغيّر.
يحدث ذلك مرارا، ونحن نلتفُّ حول ذكرياتنا القاسية، لمعاودة تذوق الألم نفسه، دون إدراك حقيقي لما قد يحدث خلال ذلك الزيّاح المستمر حولها، فقد ننجو منها وقد نقع فريسة لها فنتصرّف وفق ما تريده لا ما نريده نحن.
تحدّث سيغموند فرويد منذ أكثر من قرن عن مفهوم هذا النّوع من الذاكرة، وشخّص أنه يعتبره مصدرا للعصاب. وهذا ملعب شاسع، يمكن للأطباء وذوي الاختصاص أن يبدعوا فيه، ويمكننا أن نأخذ منه ما يبدو مناسبا لإدراكنا البسيط للأمور. يقولون كل فكرة مظلمة قد تسحب صاحبها إلى قاع مظلم في نفسه، لتصبح بؤرة معاناة يصعب علاجها، لأن أخطر ما قد يتعرّض له إنسان هو الوقوع في قبضة ذاكرة مؤلمة، تستمد كل شرورها من حدث مؤلم لا يمكن تغييره. ومع هذا تأتي الكتابة في الصف الأول لمواجهة أي مشكلة من هذا النّوع، لنقل أنها مقبرة الذكريات السيئة، وطريقة جيدة لتأبينها، والخلاص من تأثيراتها الفتاكة.
لا داعي للبحث عن أدوية بديلة للفرح المفقود، فلكل مخدّر أمد معين لانتهاء فعاليته، لقد أثبتت الكتابة أنها الريّاضة الأفضل للعقل، وأنها الوحيدة التي تمنحنا فرصة الاختلاء بأنفسنا، وكشف ما انزلق واختفى في البواطن العميقة.
حسنا يعتقد البعض أن كتابة المذكرات فيها خطورة كبيرة إذا ما وقعت في أيدِ شريرة، لهذا يُنصح بنقل المقبرة من أعماقنا إلى الورق، كون الآثار العلاجية لكتابة المذكرات ذات أهمية عالية سواء تمّ الاحتفاظ بها أو تدميرها. إنها علاج ممتاز للكآبة، والخوف، والقلق وكل المشاعر السيئة التي تحدثنا آنفا، لأنّها في خلال إعادة تركيبها، تقفز ذكريات جميلة مفاجئة، تحمل طاقة إيجابية غير متوقعة. إنّ الأمر شبيه بزيارة قبر شخص نحبه، حتى يكتمل حدادنا، في البدء نبكيه، دون احتمال فقدانه، ثم فجأة تحضر كل الذكريات الجميلة التي تركها لنا في غفلة منا جميعا، وتصبح وحدها سببا لاستحضاره.