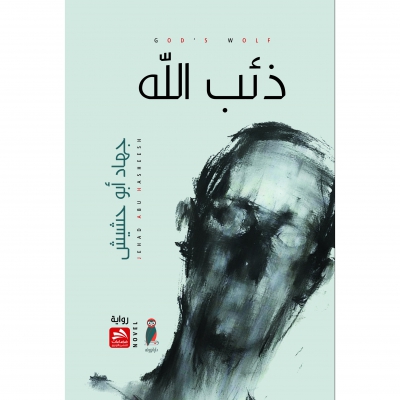*قراءة في كتاب “سميح القاسم” شاعر الغضب النبوئيّ للدكتور نبيل طنوس*
قالوا “سيماهُم في وجوههم من كثرة السّجود”، وأقول سيماهم في عناوينهم من كثرة الدلالات، فشاعر الغضب النبوئيّ لا تحمل ثلاث دلالات فحسب، دلالة الشعريّة، ودلالة الحالة الاجتماعيّة- السياسيّة/ الغضب، ودلالة الحالة الدينيّة/ النبوءة؛ إنّما يحمل العنوان فيما وراء الكلمات المكان؛ على اعتبار أنّ الغضب مشاعر وحدَث، ولا حدثَ خارجَ المكان؛ والزمان، الزمان الحاضر والمستقبل، فالحاضر هو حالة الغضب، والمستقبل له نبوءتُه الخاصّة التي ربّما تكون مناقضة للغضب، أو تلك النبوءة المتمّمة له، في كلا الحالتيْن الغضب حالة شعوريّة عابرة، بينما النبوءة فكرٌ جديد لحياةٍ مستقبليّة، فما هو سبب غضب الشاعر؟ وهل لا نكتب، وهل لا نثور إلّا من تحتِ الردم؟ وما هي النبوءة التي يحملها لنا شعر سميح القاسم، مع أنّ عصر النبوءات قد تمّ؟ كيف تجرّأ نبيل أن يُحمّل الشاعر النبوءة؟ وهل تقتصر النبوءة على المجال العقائديّ؟
أسئلة كثيرة يطرحها العنوان تستوجب وقفة تفكير وقراءة متعمّقة.
وكعادته نبيل لا يكلّ ولا يملّ، ولا يهدأ ولا يسكن، يقضي وقته في البحث والدراسة والقراءة والإبداع والترجمة، وما يميّزه أنّه صاحب رؤيا، وقد بنى تصوّرَه الفكريّ على أهمّيّة إعادة صياغة الأدب المحليّ المستحقّ، الأدب الفلسطينيّ، فكانت خطوته الأهمّ، برأيي، الترجمة، لأنّه بترجماته أوصل شعراءَنا وأدباءَنا إلى الآخَر، ترجم 100 قصيدة لمحمود درويش إلى العبريّة، وعلى هذا وحده يستحقّ منّ الحركة الثقافيّة في البلاد أن تكرّمه وأن تعطيه وسامَ التميّز الثقافيّ، ثمّ ترجمَ شعر سميح القاسم إلى العبريّة، وأتبعه بشعر راشد حسين، عدا عن ترجمات شعريّة ونثريّة للعديد من الأدباء والشعراء المحليّين؛ وتابع نشاطه في الترجمة من العبريّة إلى العربيّة، وقد تواصل مع مجمع اللّغة العبريّة وأخذ موافقتهم لنشر نقحرتهم للحروف التي اعتمدها في ترجماته، وله مقالات في هذا المجال استعملتها كثيرًا واستفدتُ منها كثيرًا عن كيفيّة اختيار الكلمة المترجَمة، وكيف يحافظ على الوزن والإيقاع، ومقالاته وترجماته سيُبدأ بتعليمها في الجامعات قريبًا، في مشروع تواصليّ جديد.
ولنعد إلى نبيل الناقد، نبيل الذي يبحث عن موادّ دراسته وبحثه بعناية، يقرأ القصيدة، يعيشها، يحفظها، يفهمها، يتّصل بأصدقائه ليشاورهم فيما توصّل إليه، يقلّب دراسته، يحفظها، يحبّها، يهتمّ بكلّ التفاصيل، نوع الورق، نوع الخطّ، لوحة الغلاف، العنوان، التظهير، الفهرس، ينشر دراسته، وحتّى بعد النشر لا يهدأ…
والسؤال المطروح: ما الجديد الذي يتناوله نبيل، ما دامت هناك دراسات أكاديميّة كثيرة حول سميح القاسم؟ وهناك من ذهب أبعد من ذلك وسأل: أتكفي ثلاثة مقالاتٍ لننشرَها في كتاب؟ وأجيبهم:
نبيل في هذا الكتاب قسّم شعر سميح تقسيميْن مهمّيْن؛ الأوّل من ناحية مضامين، والثاني من ناحية زمن؛ أمّا المضامين فكانت في ثلاث دوائر انتماء (انتماء لأنّها تبدأ من الأنا الشاعرة)، ثلاث دوائر تتداخل، تتّسع، تختلف، تتلاقى، تبدأ من القريب الضيّق إلى الأوسع، دائرة تحيطها دائرة أكبر تحيطهما الدائرة الأوسع؛ الدائرة الأولى دائرة البيئة المحيطة بسميح الشاعر، أسماها نبيل أنا الشاعر والطبيعة، عدّد فيها عشرَ قصائد من سنة 1968 إلى سنة 2010 ذكَر فيها القاسم نباتات من طبيعة بلادنا، كقصفة الفيجن والعوسج، والزنابق، والزيتونة والبرقوق والحبق والسنديان… وما إلى ذلك.
دائرة الانتماء الثانية: أنا الشاعر والوطن، ليس الوطن جغرافيّا فحسب، بل الوطن شعوريًّا، وهنا يظهر غضب الشاعر، ذاك الغضب الذي وجدناه في العنوان، الشاعر الصارخ الغاضب على ما حلّ بالمكان عبر الزمان، بدءًا من عجنةِ أمٍّ ما خُبزَتْ والشاة الّتي لم تُحلَب، والبيت الذي كسروا قنديلَه، إلى خطابِه في سوق البطالة مصرّحًا “أنا الغضب”، الذي يشذّبُ حديقتَه المتوحّش فيقول: “أنا الغضبُ
حديقتي تمتدّ من سرّي
إلى أبعدَ ما في الأرضِ من أسرار
حديقتي تنهار” (الغضب يشذّب حديقته -القاسم 1972، ص. 223؛ طنّوس ص. 32)
ومن انهيار حديقته نسمع غضبَه المغلَّف بالحبّ للأماكن:
أنا لا أشعر بالنقص ولكنّي أقول
لا لكم لكن أقول
للقرى الأطلالِ، للوادي المدمّى، للسهولِ
ليس حسبي
أنّني أعلنتُ حبّي
لبلادي ولشعبي
وأنا أعلم أنّ الموتَ بالمرصادِ
في عطفةِ درب” (“بطاقة تذكير”-القاسم 1979، ص. 691، طنّوس ص. 32 )
ومن الأطلال يصل الشاعر بغضبه إلى القدس، وفنار عكّا، إلى جبل النار في نابلس، قانا الجليل،
السجن، بلادي، الوطن، أحكي للعالَم، وجهنم…
أمّا في الانتماء الثالث الذي التفت إليه نبيل فنجد الشاعر مقابل دائرة العالم الواسع، من كوبا يغنّي مع أهلها لقصب السكّر، إلى السدّ العالي في مصر، ومن فيدل كاسترو إلى الفرنسيّ جان بول سارتر، إلى بول روبسن، أوري ديفز، نجيب محفوظ، جوني غيتار والقائمة تطول… وما يفعله نبيل هو تعريفنا بالأسماء المطروحة في القصائد، وبمناسبة القصيدة، وبمدى واقعيّة أو خياليّة أحداثها، وهكذا تغدو القصيدة بالنسبة لنا مضمونًا أجمل وأسهل وأغنى.
ومن التقسيم المضمونيّ الذي نجح فيه نبيل بجدارة إلى التقسيم الزمنيّ، فترك لسيرورة إبداع سميح بعد النكسة حيّزًا ومقالًا وقصائد شواهد. أتبعه بمقال ثالثٍ عن الألم والأمل وما بينهما متّخذًا قصيدة “تعالَي لنرسم معًا قوس قزح” نموذجًا تطبيقيًّا.
وإذا كنّا قد رأينا الغضب في قصائد سميح، فإنّ عين الصواب أن نرى النبوءة في الفكر الإنسانيّ الذي يحمله الشاعر، ويمثّل نبيل لهذه النبوءة في قصيدة سميح “عين الصواب”، تلك القصيدة التي ترجمها نبيل إلى العبريّة، وأرى أنّه من واجبنا أن نسعى كلٌّ من مكانه ومعرفته لترجمتها إلى العديد من اللّغات، لأنّها قصيدة الإنسانيّة بامتياز، لأنّها القصيدة التي لو قرأها أبناء شعبنا لقلّلنا العنف الذي يباغتنا إلى النصف، فـــــــــ”في الكون متّسعٌ لكلِّ الناس، هل في الناسِ متّسعٌ لبعض الكون؟” ، يكفيك سميح هذه القصيدة لنقول بأنّك تحمل النبوءة والسلام والرأفة والإيمان.
في هذا الكتاب ترَكَنا د. نبيل طنّوس نُعمل حواسّنا الخمس، بل الستّ؛ نشمّ روائح الوطن المعتّق في قلوبِنا، من قصفة الفيجن الّتي تركها لنا سميح القاسم في دائرة قصائد انتمائه إلى الزنابق في مزهريّة فيروز؛ نرى الجديلة والحبيبةَ والهزيمةَ وإنسانيّةَ الزمن المتروكة لنضجنا واستيعابِنا، في دائرة قصائد الوطن؛ نسمع صوتًا آتيًا من البعيد، هناك “ليلًا على باب فدريكو”، وقربَ محبرة نجيب محفوظ، وفي عزف جوني ليوميّاته على الجيتار، وفي صوت قُبلةِ الأمّ المطبوعة على جبين الشاعر؛ نلمسُ الغضبَ والنارَ في الكلمات الحمراء؛ نلمس التضادّ يتراخى في الإردافات الخلُفيّة التي يجمعها الشاعر فيشدّها نبيل بالتفاته إليها؛ نذوق رشفات ماء “البئر العذراء التي تسقي العامل والفرّان وأطفال الحارّة”؛ ونُعمل حاسّتنا السادسة في تقصّي نبوءة الشّاعر التي يطرحها الكتاب، تلك النبوءة التي تتنبه إلى أنّه “في الكون متّسَعٌ لكلّ الناسِ والأشياء والأسماء”، نُعمِل حاسّتنا السادسة التي أيقظها نبيل لندور مع سميح في دوائره الشعريّة: الطبيعة، الوطن والعالَم.
هنيئًا لنا بباحثين يسبرون أغوار الكلمات، هنيئًا لنا أنّ سميحًا بعلَ الباعثَ الخصبَ في الكلمات هو شاعرنا.