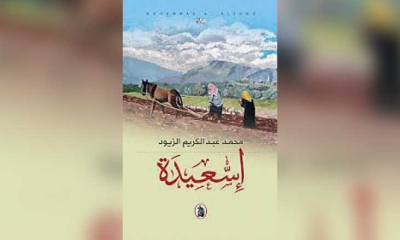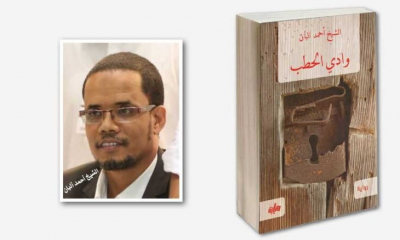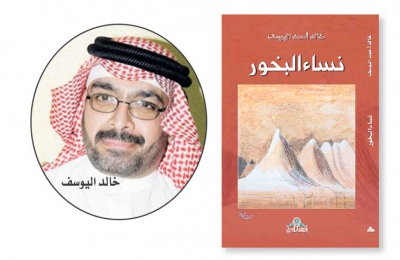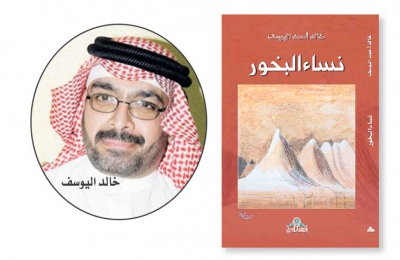
الكتابة الروائية عن الحاضر والمستقبل ضرورية جداً؛ لما تكشفه من وقائع وأحداث وتفاعلات، وتثيره من أسئلة، وتسببه من حيرة وبلبلة لها مفعولها السحري. وليس من المبالغة القول إنَّ الكتابة عن المستقبل، تُعبِّر عن إدراك تام بالمسؤولية المُلقاة على عاتق الكاتب؛ لما ينثره أمام المهتمين من رؤى وآفاق وأحلام وآمال، وسبل تقود إلى المستقبل، بخطى واثقة على أرض صلبة.
وفي الجانب الآخر فإنَّ الكتابة عن الماضي ونبشه، وخاصة المراحل المنسية أو المهمشة من التاريخ مهمة جداً؛ لما فيها من دلالات وتفاعلات وتحركات وجهود، تفيد بالتأكيد في تقييم هذه المراحل ودراستها، وأخذ الدروس والعبر منها؛ كونها المراحل التي تشكل الجذور المتشعبة والأسس المتينة؛ لتنفي عن المجتمعات والدول أي تهمة بأنها لقيطة أو طارئة أو أنها نبت شيطاني.
رواية «نساء البخور» للروائي السعودي خالد أحمد اليوسف، تتناول مرحلة التأسيس والبدايات والبساطة في مدينة الرياض، قبل الطفرة النفطية التي غيرت كل شيء، مرحلة ستينيات القرن العشرين، حيث كان العرب جميعاً يبحثون عن وجود لهم، وخلاص من عدو يجثم على صدورهم. مرحلة تميزت بالأحداث السياسية التي غيرت كثيراً في معالم المنطقة، ابتداء في اليمن وانتهاء عهد الإمامة، وفلسطين حيث ضاعت بقيتها وأجزاء من مصر وسوريا، وضاعت قبل كل شيء كرامة العرب «تهاوت الأنفس والمشاعر في الأيام التالية ليوم الهزيمة، وارتسمت ملامح الحزن على وجوه كثيرة ممن يرتادون سوق المقيبرة، واقتسم هذه الصدمة عدد كبير من البائعين والجائلين والعاملين»، وألقت الهزيمة ظلالها السوداء على الجميع بمن فيهم الوافدون اليمنيون «هي الغربة التي رضوا بها، وهو المصير الذي سلكه كل واحد منهم للبحث عن نفسه وعن يوم مختلف، لكن صدمة الهزيمة التي انبثقت منها غربتان؛ غربة الوطن الصغير والبلاد التي خلفها وراءه من أجل المستقبل، وغربة الوطن العربي الكبير الذي تمزق فصار أشلاء مبعثرة، وكان وجلهم من الغد الذي لا يدرون ما يكون بعده، أيبقون هنا أم يعودون بأيدٍ خالية؟»، وانتهت المرحلة الثقيلة بوفاة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله.
عنوان الرواية «نساء البخور» (دار الانتشار العربي، بيروت، 2012) يوحي برواية عن النساء المخمليات المترفات اللواتي لا هم لهن إلا العطر والبخور والقيل والقال، ولكن الرواية تأخذنا إلى الجانب المعاكس تماماً، إلى النساء اللواتي اضطررن تحت وطأة الحاجة والفقر وقسوة الظروف إلى العمل، وترك حياة البيوت وما يواكبها من ملذات ومتع.
اهتمت الرواية بالتفاصيل الدقيقة جداً، وخاصة لسوق المقيبرة الذي صورته لكأننا نراه بمكوناته وتعرجاته وخفاياه، بمن فيه من نساء ومتبضعين ومارة وتجار، وبسطات وبضائع وغير ذلك، مما يشكل حياة السوق ووجوده. ومن هنا يمكن اعتبار المكان بشكل عام وسوق المقيبرة بشكل خاص البطل الرئيس للرواية، ولا عجب فالمكان هو أساس الوجود والانطلاق، والسوق أي سوق هو نبض المدينة ومقياس لتفاعلاتها ومتغيراتها وأحداثها وما يمور داخلها، خاصة الأسواق الشعبية ملجأ وملاذ الطبقة الشعبية والوسطى، ولا تعدم متبضعين من علية القوم وأغنيائهم، فالحياة الحقيقية دون رتوش أو أقنعة تكون في الأسواق والأحياء الشعبية.
في سوق المقيبرة يباع ويشترى كل شيء مما يحتاجه الناس البسطاء، ومما يمكن أن تمارسه النساء من تجارة وبيع وشراء، من الملابس والسلال والحبوب وحاجيات النساء، والأعشاب والمشغولات اليدوية والأحذية والإكسسوارات والأطعمة والحلويات الشعبية والبيض والزبد والدجاج والحمام والأرانب وصغار الماعز والخراف، والكتب والمجلات القديمة، وغير ذلك مما لا يمكن حصره، مما يمكن أن يخطر ولا يخطر على البال. وهي سوق لا تختلف عن مثيلاتها في المدن الكبرى في كل بقاع الأرض.
وقد صورت الرواية سوق المقيبرة بأنها كائن حي ينمو ويتمدد : «هي تكبر وتنمو سريعاً وتأكل البيوت والأحواش الفارغة والنخيل من حولها، حتى وصلت إلى كل الأحياء المحيطة بها، ها هي «المقيبرة» تصبح علماً للرياض بعد اشتباكها بسوق سدرة وقيصرية (السوق المسقوفة) الحساوية من الشرق، وسوق أقمشة الجملة والأحذية، وسوق الجفرة والأواني المنزلية، وقيصرية الصرافين والعطارين من الشمال»، وهذا النمو طبيعي متوقع بسبب الزيادة الطبيعية في عدد السكان، بالإضافة إلى الوافدين اليمنيين وغيرهم.
وقد نجح الكاتب في نقل صورة الحياة وتشابكاتها داخل سوق المقيبرة، وما يكتنفها من خلافات ومناكفات وتدخلات ومشكلات، وصراعات خفية، وعواطف مستترة أو مجروحة، وعلاقات مشبوهة وغير مشبوهة. البطولة الثانية في الرواية كانت للمرأة بلا منازع، حيث كانت القائدة والتاجرة وصاحبة القرار، في حين قبع الرجل في الظل، تابعاً منفذاً لأوامر النساء، ملبياً لطلباتهن، أو مطارداً لهن كسباً لودهن. ولم تخرج المرأة إلى السوق ترفاً أو بطراً، بل اضطراراً لمدافعة الفقر والحاجة، أو للتغلب على بخل الزوج وجحوده.
وتبوأت مريم الورقاء وأم زيد الصدارة، كنموذجين مختلفين متنوعين؛ فمريم كانت زعيمة سوق المقيبرة، التي تتابع كل حركاته وسكناته، وتضع قواعده وتعليماته. أما أم زيد فقد انضمت إلى السوق في غياب مريم، وشكلت تهديداً لمكانتها وسلطتها، وحدث صراع خفي بينهما: مريم لإثبات سلطتها، وأم زيد رفضاً للتبعية والخضوع. وقد مثلت مريم السلطة بما لها من دالة على نساء السوق، وفرض إرادتها، بينما مثلت أم زيد قوة الوعي والثقافة والتنوير، فقد تعلمت على يد صديقتها مزنة بنت أحمد، فتعلمت القراءة والكتابة والحساب وحفظت القرآن الكريم، وقرأت الكثير من المجلات والصحف، وتوجت ذلك بشراء راديو ببطارية لمتابعة التطورات والأحداث في السعودية وما حولها، وظهر دورها وتأثيرها القوي في أثناء نكسة 1967 وما تلاها، وحديثها للنساء وتوعيتهن بما حدث أو يمكن أن يحدث.
هذه الثنائية بين مريم وأم زيد أحدثت التوازن المطلوب والتأثير المرجو. وهي ثنائية غير مألوفة في مجتمعاتنا العربية، خاصة في تلك المرحلة، فالمرأة كانت قعيدة البيت، لا تهتم ولا تشارك إلا فيما ندر. ولكن «نساء البخور» قدمن نماذج متميزة في زمان ومكان غير متوقعين.
الصراع الخفي بين مريم وأم زيد انتهى بتعهد أم زيد بتدبير أمر زواج مريم من زوج صديقتها مزنة، بعد أن رفضته هي حفاظاً على صديقتها، وكرهاً للرجال بعد تجربتها المريرة مع زوجها السابق. ومع أن مريم كانت عازفة عن الزواج، تصد من يتقرب إليها، لكنها لم تستطع أن تصمد أمام الوجيه أحمد، فتمنته زوجاً لها، بعد أن أسرها طيفه، ممزقاً شرنقتها وحصنها المنيع. فتعهدت لها أم زيد أن تحقق لها ما تريد؛ تأكيداً على أن المرأة مهما بلغت من مكانة وسيطرة وقوة، فلا بد أن تأوي إلى رجل تشعر معه بالأمن والأمان، ليحقق لها كينونتها، ويكشف لها سرَّ وجودها، تقول مريم الورقاء: «ما أظن الرجّال يبيّن رجولته إلا مع المرة، وهي مثله ما أظنها تصير مرة إلا مع الرجل».
تناولت الرواية في ثناياها العمالة اليمنية وتكاتفها التي كانت متواجدة بقوة في الأسواق الشعبية في الرياض وغيرها من المدن السعودية، كأحد إفرازات الحرب اليمنية في تلك الفترة، وأبرزت اهتمام الشباب اليمني العامل في الرياض بالعلم والتعلم، ورفضهم لأي أعمال إجرامية ضد المملكة وشعبها. كما أشارت الرواية إلى استقبال الرياض للفلسطينيين بعد حرب 1967، وتوفير العمل لهم في جو من الحب والحفاوة والتقدير.
البحث عن الذات وإثبات وجودها واستقلاليتها، برز بوضوح في الرواية من خلال معظم شخوصها، فمريم الورقاء وجدت نفسها زعيمة لسوق المقيبرة، فلا تخرج امرأة عن شورها، وأم زيد استقلت عن زوجها وشقت لنفسها طريقاً في الحياة والسوق فهي « لم تحب العمل والبيع والشراء بالمقيبرة إلا بسبب واحد، وهو وجود الرجل والمرأة في مكان واحد، ولكل واحد منهما مكانه واحترامه، وأنها تكون مسرورة حينما تأتي إلى هنا لأنها تجد مكانها الحقيقي من غير تسلط أو تملك أو أمر ونهي مع احترام كامل للمرأة وحقوقها». وكذلك مزنة بنت أحمد التي عملت خياطة في بيتها لتؤكد استقلالها عن زوجها البخيل، وأنها تستطيع أن تدبر أمرها بنفسها. وجميع الوافدين اليمنيين قدموا الرياض للبحث عن العمل والعيش الكريم والإقامة الآمنة، لتحقيق طموحاتهم وآمالهم التي عصفت بها رياح الحرب في اليمن.
لغة الرواية سلسة لطيفة، مزجت بين العامية والفصحى حسب الشخصيات ولهجاتها ومستواها الثقافي. واختتمت الرواية بسرد إيضاحات لبعض ما ورد فيها من كلمات محلية، قد تُشْكِلُ على البعض فلا يعرف معناها أو مدلولها، وهذا مما يسجل للرواية، وإن كان الأفضل أن يرد الإيضاح حيثما وردت الكلمة، فهذا أدعى للتواصل والفهم والمتابعة، دون أن يشعر القارئ بوجود فجوة هنا أو هناك.
تطورت أحداث الرواية في خط متصاعد حتى نهايتها المفتوحة، ويبدو ذلك مفهوماً بالنظر إلى موضوعها والمرحلة التي تتناولها. وحفلت بالعديد من الإشارات السياسية والاجتماعية والثقافية الذكية بين السطور.
وبعد، فرواية «نساء البخور» لها فضل استكشاف وتوثيق مرحلة ضبابية مجهولة عند جيل اليوم، الذي اجتاحته حمى التكنولوجيا وثورة الاتصالات وجنون الحياة، فقطعته عن ماضيه القريب، وجذوره الراسخة، فكانت هذه الرواية؛ لتذكره بالبدايات ومرحلة التأسيس، وحسبها هذا الفضل.
والأمل أن يعود الأدباء السعوديون إلى تلك المرحلة وما سبقها في الرياض وغيرها من مدن وقرى المملكة، وتقديمها للقارئ في قوالب سردية ممتعة؛ للمحافظة على مرحلة قد تضيع، ويلفها النسيان.